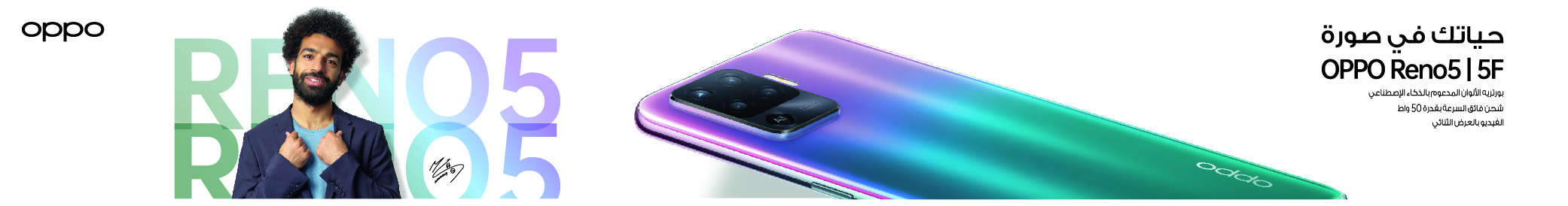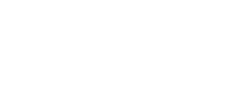الأردن بلا معجزة اقتصادية… ولكن بفرصة حقيقية

البرفسور عبد الله سرور الزعبي
مركز عبر المتوسط للدراسات الاستراتيجية
لم تتشكّل أزمة الاقتصاد الأردني بين ليلة وضحاها. ما نعيشه اليوم هو حصيلة مسارٍ طويل من الخيارات السهلة، والإدارة المتردّدة، والتعامل التكتيكي مع المشكلات بدل بنائها استراتيجيًا. عقود من السياسات المتقطّعة والشعارات المؤجّلة صنعت منظومة إدارية تتردد، وتخشى التغيير العميق، وجعلت من السلامة الإجرائية بديلاً عن الجرأة الإصلاحية. المشكلة لم تكن في نقص الموارد فقط، بل في طريقة التفكير في إدارتها. والسؤال، هل اديرت كملف مالي، أم كمحرّك لإعادة بناء الاقتصاد؟
هذا الواقع مركّب، فلا يمكن اختزاله في رواية السوداوية، ولا في قصة نجاح حتمية. نحن أقرب إلى منطقة رمادية، تتحرك فيها المخاطر جنبًا إلى جنب مع الفرص، وهذه ما يكشفه لنا تشرشل "الأزمة هي فرصة ترتدي ثوبًا قبيحًا".
لكن ما يواجه الأردن، ليس قدرًا محتومًا، فالدولة تمتلك خبرة مؤسسية، واستقرارًا سياسيًا، ودولة امنه، ومكانة دولية مكّنتها من تجاوز أزمات خطيرة، بل اختبارًا حقيقيًا لقدرته على توظيف الإمكانات الكامنة في الدولة والمجتمع.
والاهم اتساع الفجوة بين الرؤية الملكية والتنفيذ اليومي داخل مؤسسات الدولة. التوجيهات الملكية، تُطرح بوضوح قضايا، الإصلاح الإداري، ربط التعليم بسوق العمل، التمكين، الحوكمة، والشفافية، والمساءلة، والعدالة في الفرص، وجلب الاستثمار. غير أن هذه الرؤية المتقدمة اصطدمت بجهاز تنفيذي يعاني من الخوف من القرار، وغياب الاستمرارية، ولجان تفريغ الأفكار من مضمونها، واحياناً ضعف الكفاءة. وهنا تشكل لدينا دولة تعرف ما تريد، لكن لا تملك أدوات كفاية للتنفيذ.
في المقابل، لا يمكن تجاهل أنه كان محاولات لإعادة تنظيم الإدارة، وخطط لتطوير الخدمات الرقمية، وإطلاق برامج إصلاحية، لكنها ما تزال تحتاج إلى انضباط مؤسسي ومحاسبة حقيقية كي تؤتي ثمارها.
خلال سنوات اديرت ملفات الاقتصاد بعقلية إطفاء الحرائق، وإدارة لا تقود السوق بل تلاحقه، ولا تصنع الفرص بل تفسّر غيابها. أخطر ما يواجه الدولة الحديثة ليس النقد، بل شبكات النفوذ الصامتة، التي تعمل على تدوير الأشخاص، أسماء تتنقل دون تقييم جاد للأثر والأداء.
حين يرى المواطن أن التدوير يحل محل التقييم، وان المنصب يأتي كنتيجة لتوازنات، ومحسوبيات، وتسويات، وان الإدارة تحرص على الاسترضاء والمهادنة، وتعمل على خلط الإنجاز الحقيقي بالتزين الرقمي، وتقديم الإدارة الإعلامية على الإدارة الفعلية، تتآكل فكرة العدالة، وتُصاب الثقة العامة.
بهذه العقلية، تصبح المؤسسات مختبرًا للتجارب، ويُعاد التدوير، وكما قال بيتر دراكر "الادارة التي تسمح بتكرار الأخطاء هي الخطأ نفسه".
الخطير أن هذا النمط الإداري لا ينهار، بل يتكاثر، لأنه محمي بشبكة مصالح والتوازنات لا بالمحاسبة.
على مدار سنوات، تعددت الخطط الطموحة، وخطط جاءت كردّ فعل للأزمات، وتكررت البرامج الإصلاحية، الا انها تغيرت بأسرع من قدرتها على أن تُثمر. الأهم ان آليات التقييم والمساءلة لم تُفعّل. وهكذا تكاثرت الوثائق، فيما ظل الواقع يتحرّك ببطء شديد. بهذه الطريقة، تحوّلت بغض المؤسسات، إلى مدرسة تدريب، لتجريب نظريات على الورق.
الرئيس الأمريكي الأسبق آيزنهاور قال "الخطة لا تهم بقدر ما يهم التخطيط والتنفيذ". لدينا خطط، لكن التخطيط التنفيذي، بما فيه الجرأة، والمتابعة، والمساءلة، لا يزال الحلقة الأضعف، هنا تكمن الفجوة بين الرؤية والواقع.
منذ التسعينيات، اعتاد الأردنيون سماع وعود بالمشاريع الكبرى وتدفقات الاستثمار، لكن كثيرًا من هذه الوعود صدرت من بعض ما يمكن وصفهم بالمنظرين، بشّروا بالحلول الكبرى ثم غادروا بلا نتائج، وبعض المغامرين، ممن أغرقوا البلد بأرقام استثمارية ضخمة تُطرح في المؤتمرات او في لقطات إعلامية فقط.
الذريعة كانت دائمًا واحدة، الظروف صعبة، والضغوط كبيرة، والمرحلة لا تحتمل. نعم، الأردن تحت الضغوط، لكن أصحاب الذرائع، تناسوا ان المدير، الذي يبحث عن الأعذار أكثر مما يبحث عن الحلول، يقود مؤسسته نحو الفشل. ولم يتذكر أحد منهم قول لي كوان "لا تُبنى الدول بالشعارات، بل تُبنى بالانضباط والعمل والنتائج". وهكذا تحول الاقتصاد في مراحل عديدة الى سوق وعود لا سوق إنتاج.
الإدارة ليست العائق الوحيد للاقتصاد، لكنها إذا لم تُحدّث، تبقى المكبح الأخطر. وفي المقابل، فإن تحريرها من التعقيد، وبناء قيادتها على الكفاءة سيحوّلها، كما في تجارب سنغافورة، وكوريا الجنوبية، وفيتنام، وفنلندا، ورواندا، وغيرها. وهي دول خرجت من أزمات أشدّ، لكنها امتلكت ثلاثة عناصر حاسمة، قيادة تنفيذية صارمة، إدارة شفافة، وتعليمًا مرتبطًا بالإنتاج، وطبقت قاعدة دراكر الذهبية "الإدارة هي تحويل الموارد إلى نتائج"،
الفارق لم يكن في النظريات بل في الانضباط والمسؤولية، وهذه كانت عقدتنا. ليس المطلوب استنساخ التجربة، بل التقاط الفكرة، ويمكن للأردن امتلاكها بسهولة إذا أُغلقت ثغرات التنفيذ.
صحيح ان الإدارة العامة، تعاني إرثًا طويلًا من التعقيد المؤسسي، لكنها في الوقت نفسه تمتلك الكوادر والخبرات القادرة على التنفيذ متى توفرت الإرادة والبيئة الداعمة. لكنها ما تزال بحاجة إلى تعميق ثقافة التقييم بدل ثقافة السلامة الإجرائية.
أحد جذور الإشكالية، أن بعض من تولّوا الملف الاقتصادي تعاملوا مع المالية بعقلية ضبط دفاتر الحسابات (ضبط الإيرادات وخفّض النفقات، وسدّ الفجوة، والتركيز على الجباية، لا بمنطق تحفيز النمو، وصناعة الثروة). الا انه غاب عن البعض، فكر مهندس الاقتصاد بالتعامل بمفهوم التنمية، لا بمفهوم التحصيل، وإدارة الاقتصاد كمنظومة تصميم تجعل من المالية العامة أداة استثمار، كيف تُبنى الصناعة؟ كيف تُحفَّز الزراعة؟ كيف يُخلق العمل اللائق؟ وكيف تتحول الضرائب من عبء إلى محرك للنمو؟ وكيف تستثمر في التعليم، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، وغيرها.
خلال السنوات الأخيرة، حصل الأردن بفضل جهود الملك على منح وتمويلات ميسرة بمليارات الدولارات، وُجهت إلى مشاريع بنية تحتية، وطاقة، وتعليم، ومياه، وتنمية محلية وغيرها. لكن بعض هذه المشاريع تعرقل، أو لم يُنفّذ بسبب البيروقراطية، وتضارب الصلاحيات، وتأخر في طرح العطاءات، ومشاريع بدأت ثم تعطلت، لأن الدراسات لم تكن عميقة أو لأن البيئة القانونية غير مناسبة، وغيرها. في بعض الحالات تكبّدنا فوائد على قروض لم تُصرف (تقرير ديوان المحاسبة الأخير).
من الملاحظ، انه لم يُحاسَب أحد على مشروع لم يكتمل، أو وعد لم يتحقق، أو منحة وقرض لم ينفق. حين تغيب المحاسبة، تتراكم الأخطاء.
على مدار عقود، تعاملت الحكومات مع الاقتراض كحلّ مريح لتغطية عجز الموازنات. مع الزمن أصبح القرض يستدعي قرضًا أكبر. وتحوّل الدين إلى عبء، ومعه رُحِّلت القرارات المؤلمة، وتأجل الإصلاح الضريبي الحقيقي، وظلّت الازمة المالية أسيرة نفقٍ طويل. المشكلة لم تعد رقمًا ماليًا، بل استنزاف للمستقبل. وهي الحالة التي أشار اليها، الاقتصادي غالبرايث "خطر الدين ليس في حجمه فقط، بل في السلوك الذي يخلقه".
المديونية ليست لعنة جغرافيا، بل نتيجة سياسات مالية استسهلت الاقتراض لسد العجز بدل معالجة أسبابه، ورفع الضرائب بدل توسيع القاعدة الإنتاجية لزيادة النمو.
لكن الصورة الإيجابية هنا أن الأردن نجح، رغم الضغوط، في الحفاظ على سمعته الائتمانية واستمراره بالحصول على تمويلات ميسرة، وهو ما يشير إلى ثقة دولية يمكن البناء عليها إذا تحوّلت القروض إلى استثمارات إنتاجية لا مجرد تغطية للعجز.
خلال السنوات، انعكس الأداء على بيئة الأعمال. حتى اصبح يقال بان الأردن طارد للاستثمار. في الحقيقة، هذا حكم ليس في محله. فهناك بيئة تشريعية حديثة نسبيًا، وبنية تحتية لا بأس بها، واستقرار سياسي وأمني مهم. لكن في المقابل، يقف المعوّق الأبرز في الإجراءات، وتذبذب السياسات وغموضها احياناً. المستثمر لا يهرب من الضرائب فقط، بل من الغموض وتبدّل القوانين وتعدد المرجعيات، فالغموض هو العدو الأول للمستثمر.
كثير من المؤتمرات أعلنت مليارات من المشاريع الاستثمارية، لكن ما تحوّل إلى واقع كان محدودًا. فالبيئة التنظيمية لم تكن مستقرة بما يكفي، والقرار الإداري بطيئًا وحذرًا إلى حد الشلل، فغادر بعض المستثمرون، فضاعت الفرص، وبات الاقتصاد، في مراحل، سوق وعود لا سوق إنتاج.
هنا يصبح السؤال، هل نُبقي الاقتصاد في منطقة آمنة رمادية، لا ينهار ولا ينمو، أم نمتلك الجرأة على تصميم قفزة منظمة ومدروسة؟
المطلوب اليوم، الانتقال من ثقافة الترخيص إلى ثقافة الشراكة، حيث يشعر المستثمر أن الدولة رفيق في النجاح. عندها سيكون هناك مزيداً من الاستثمار في الكثير من القطاعات، مثل التكنولوجيا المالية والسياحة، والطاقة وغيرها. هناك قصص نجاح مهمة يمكن البناء عليها إذا استقرّت التشريعات، وتبسطت الإجراءات، وسياسات طويلة الأمد كي تتحول إلى محرك نمو حقيقي.
ان الزيادة في الاستثمار، سيقلص من البطالة، ويرفع ثقة المواطن، وكذلك يعزز من متانة العقد الاجتماعي.
البطالة، ليست في نقص الوظائف فقط، بل جزء كبير منها يعود الى فشل بنيوي في الربط بين التعليم والإنتاج. فأصبح لدينا، آلاف الخريجين سنويًا بلا خطة وطنية واضحة لتوظيفهم أو إعادة تأهيلهم أو استيعابهم في اقتصاد منتج.
التعليم يختصر قصة الأردن، نجاحات أكاديمية لافتة في الخارج، مقابل تحديات بنيوية في الداخل. الجامعات ليست ضعيفة بالمطلق، لكنها محاصرة بين التمويل وتضخم الإدارات، وضغوطات اجتماعية وسياسية، وضعف في بعض الادارات. هناك قصص تميّز، وهناك مواطن خلل تحتاج معالجة شجاعة. الجامعات لم تضعف بسبب نقص العقول، بل لأن بعض الإدارات، خضعت أحيانًا للحسابات لا للمعايير، وأصبح بعضها يبحث عن الإيراد أكثر من المعرفة.
حين يختنق التعليم يختنق الاقتصاد كله، فلا دولة نهض اقتصادها وتعليمها ضعيف. هكذا أصبح التعليم الضحية والشريك في آن واحد. وعلينا ان نتذكر دائماً بان التعليم، هو رئة الاقتصاد المنتج.
رغم الدعوات الملكية المتكررة لإصلاح التعليم، بقي التنفيذ رهينة بعض العقليات، التي لا تمتلك رؤية عصرية، ولا ترى في الجامعة سوى ميزانية، لا مشروعًا معرفيًا.
الى اليوم، لم يطرح سؤال، ما نوع الاقتصاد الذي نريده؟ وما نوع الإنسان الذي يجب أن نُعدّه له؟ غياب هذا السؤال جعل البطالة تتحول من مشكلة تعليمية واجتماعية مؤجلة، الى ازمة متفاقمة.
الرؤية الملكية خلال العقود، رسمت ملامح مشروع دولة حديثة واضح المعالم، اقتصاد منتج، وتعليم نوعي مرتبط بالاقتصاد، إدارة كفؤة، وعدالة في الفرص، والمساءلة، والحوكمة، وتحرير الإدارة من البيروقراطية. لكن الجهاز التنفيذي ظل أبطأ من الرؤية، هكذا اتسعت الفجوة.
في مثل هذا الوضع، يظهر السؤال، لماذا فشلنا حيث نجح غيرنا؟
الأردن جرّب معظم المدارس الاقتصادية، الخصخصة والتحرير والشراكات والتقشّف، لكن التنفيذ كان في الغالب كان نصّيًا، وبلا دراسات مستقبلية، وفهم عميق، بيعت ألاصول دون بناء بدائل إنتاجية، وتحرير أسواق دون حماية اجتماعية، واستثمارات بلا إدارة مرنة، ونقص في الشفافية والمحاسبة.
ومع ذلك، فإن بعض المشاريع في البنية التحتية وقطاع التكنولوجيا والرقمنة، أثبتت أن التنفيذ ممكن عندما تتوافر الإرادة والإدارة المنضبطة، لكنها ما زالت حالات تحتاج إلى تعميم.
لم يعد السؤال اليوم حول ضيق الموارد. التجارب العالمية تقول، الدول التي تُحسن الإدارة تتقدم مهما كان حجمها، وتلك التي تُسيء الإدارة تتراجع مهما امتلكت من ثروات. مشكلتنا الأساسية هي الفجوة بين التخطيط والتنفيذ. لدينا استراتيجيات واموال المنح والمساعدات، والمشاريع طُرحت، والخطط امتلأت بها الأدراج، والقطاعات تلقت الدعم، ومع ذلك بقيت المسافة كبيرة، الا انها قابلة للاختصار إذا تحولت الرقابة والمساءلة إلى ممارسة يومية.
وهنا، لم يعد السؤال، هل نعرف أين الخلل؟ فالدولة تدرك الخلل، وتُشخّصه بدقة، والمشكلة ليس في غياب الحلول، بل غياب الإرادة لكسر شبكات النفوذ ومحاسبة الفشل، حيث الازمة لم تعد مالية فقط، بل معركة مع الوعي.
النهضة ليست معركة ضد أشخاص، بل معركة ضد ثقافة إدارية ترسخت لعقود، والتاريخ، كما يقول تشرشل، لا يكافئ من لا يجرؤ على المتابعة.
وهنا يبدأ السؤال، لماذا لا تتحول الفرص إلى نتائج؟ ولماذا بقي الاقتصاد أسير الوعود لعقود متتالية؟
نحن اليوم أمام لحظة حاسمة، إمّا دولة تخطط وتنفذ وتحاسب، أو حلقة متكررة من الوعود المؤجلة. الأردن ليس بلدًا فقير الإمكانات، لكنه عانى من إدارة تُفضّل التجريب على اتخاذ القرار الصعب.
اليوم، نرى ان رئيس الوزراء لديه جدية واضحة في متابعة المشاريع والوصول الى نتائج ملموسة، كيف لا، وهو صاحب كتاب "الاقتصاد السياسي الأردني...بناء في رحم الازمات"، فهو المطلع والخبير، الا اننا احياناً نجد أنفسنا امام تصريحات مختلفة من بعض أعضاء الفريق، بحاجة الى توضيح. على سبيل المثال، تكلفة الناقل الوطني، بين وزير سابق يتحدث عن 3.6 مليار تقريبا، وتصريح جديد يقول بان التكلفة قد تصل الى 6 مليار!، وبين تصريح سابق عام 2022 باننا سننتج 200 مليون قدم مكعب من الغاز في عام 2025، واليوم لم يصل الإنتاج الى 10℅ مما أعلن، فماذا حصل؟ ويتم وعدنا، باننا سنصل الى انتاج 418 مليون قدم مكعب من الغاز عام 2030، وماذا ان لم نصل الى ذلك؟ وإنتاج النفط، قيل بانه سيغطي تكلفة المسح السيزمي في الجفر بحوالي 29 مليون دولار، والإنتاج لا يتجاوز عشرات البراميل اليومية (حسب معطيات شهر أيلول 2025)، واعمال التنقيب في وادي عربة، التي ننتظر نتائجها منذ سبعة عقود تقريباً. كلها مشاريع أساسية لمستقبل الامن الاقتصادي الأردني. ان بعض التصريحات بحاجة الى ضبط ومراجعة وتوضيح، قبل ان ندخل في مرحلة التفاؤل الكبرى، ونفاجئ فيما بعد بغير ذلك لا قدر الله.
اننا نثق بان رئيس الوزراء يعمل جاهداً لتحقيق الرؤية الملكية، واستعادة الثقة، التي تبدأ من ثلاث قواعد بسيطة وعميقة، المسؤولية قرينة السلطة، والتعليم أولًا، والإدارة فوق الشعارات (المشاريع تُقاس بما ينجز، لا بما يُعلن).
الأردن، لا ينقصه موقع، ولا علاقات دولية، ولا استقرارًا سياسيًا، وفرصه ليست قليلة، والاهم انه يمتلك قيادة هاشمية فريدة من نوعها، قدمت صورة متقدمة للأردن في الاعتدال والاستقرار والتوازنات السياسية، وحصل بفضلها على دعمٍ كان يمكن أن يصنع فارقًا كبيرًا.
فالخروج لا يبدأ بقانون جديد ولا باستراتيجية إضافية، بل بلحظة صدق وطنية تعترف أن الازمة داخلية، وشجاعة تنفيذ، وانضباط مؤسسي، وإرادة ترى في الوقت موردًا لا مساحة للتبرير.
فالمرحلة المقبلة لا تحتمل المساومة، التاريخ لن يسألنا كم وعدنا، بل كم نفذنا، فكما قال تشرشل "النجاح ليس نهائيًا، والفشل ليس قاتلًا، الشجاعة في المتابعة هي ما يصنع الفرق".
الطريق اليوم صعب، لكنه الطريق الوحيد، لسنا بلدًا بلا فرص، ولسنا شعبًا بلا كفاءة. لكن اقتصادنا أُنهك، فالسياسة سبقت الإدارة، والوعود سبقت التنفيذ، والظروف سبقت الإرادة.
الأمل هنا واقعي، فالمقومات موجودة، والرؤية واضحة، وما ينقص هو الإرادة المؤسسية لكسر ثقافة التأجيل، وتحويل التنفيذ إلى ثقافة وطنية، وتحويل الموارد إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية. المستقبل ملكًا لمن يعمل.