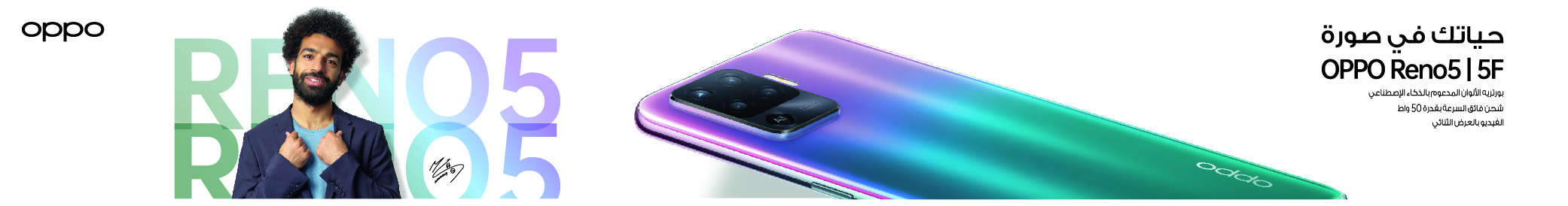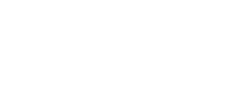المقاربة الاستدعائية: دراسة تطبيقية في رواية «أجراس القبار» للأديب مجدي دعيبس

بقلم: أسيد الحوتري
تُعد المقاربة النقدية الأدبية الاستدعائية رؤية جديدة في تحليل النصوص الأدبية، تقوم على دراسة العلاقة التفاعلية بين النص الأدبي وما يثيره من صور ورموز وأحداث كامنة في الذاكرة الجمعية للقارئ، بحيث يصبح فعل القراءة عملية استدعاء ثقافي تُسهم فيها ذاكرة الجماعة في توليد المعنى وتوسيعه. فالنص، في هذا التصور، لا يُقرأ في فراغ، بل يُقرأ ضمن فضاء ثقافي شامل تتداخل فيه الأبعاد التاريخية والدينية والإنسانية، حيث تتشابك التجارب والرموز والصور المختزنة في الذاكرة الجمعية للقارئ، فيغدو فعل التلقي عملية تأويلية حية يُعاد من خلالها إنتاج المعنى وتوسيعه.
تفترض "الاستدعائية" أن مكوّنات النص الأدبي، من مشاهد وصور ورموز وإشارات لغوية، لا تعمل بمعزل عن الوعي الجمعي للقارئ، بل تؤدي وظيفة تحفيزية تستدعي من ذاكرته الثقافية صورا وأحداثا موازية أو مشابهة، بما يُنتج طبقة موازية من المعنى تتجاوز حدود النص المباشر نحو أفق رمزي وإنساني أرحب. وبهذا يغدو النص كيانا متحركا يعيد إنتاج ذاته داخل الوعي الجمعي في كل عملية قراءة جديدة، إذ يتجدّد معناه بتجدّد الذاكرة التي تتلقاه. كما يمكن لعملية الاستدعاء أن تنبثق من أصغر وحدات النص: من كلمة مفردة، أو جملة عابرة، أو رمز عارض، لأن الذاكرة الجمعية للقارئ لا تستجيب للنص بوصفه كُلا مغلقا، بل تتفاعل مع ومضاته الدلالية الجزئية التي تُحرك فيه مخزونا رمزيا وثقافيا متجذرا في وعيه الجمعي. وبذلك، يتأكد أن فعل القراءة في المقاربة الاستدعائية هو عملية تأويلية ديناميكية، تُعيد إنتاج النص في ضوء الصور الذهنية والثقافية التي يستدعيها، لا في ضوء معناه الأصلي فحسب.
ترتكز المقاربة على جملة من الدعائم النظرية التي تشكّل إطارها المعرفي. فمن "جماليات التلقي" كما صاغها (هانس روبرت ياوس) و(ستينلي فيش)، تستمد فكرة أن القارئ شريك في إنتاج المعنى، وأن النص لا يكتمل إلا بفعل القراءة. ومن نظرية "الذاكرة الثقافية" لـ (يان أسمان) و(رايموند ويليامز)، تستعير المقاربة رؤيتها بأن الوعي الجمعي يشكّل الحاضن الذي يُعيد من خلاله القارئ بناء النص ضمن سياقات دينية وتاريخية مشتركة. أما مفهوم "التناص القرائي" الذي قام على ما أسسه سالف الذكر (هانس ياوس) و(فولفغانغ إيزر) في إطار نظرية التلقي، والذي يعد تطويرا لاحقا لمفهوم التناص الذي صاغته (جوليا كريستيفا)، فيُبرز قدرة القارئ أيضا على خلق شبكة من العلاقات بين النصوص، لا الكاتب وحده. كما ترتكز المقاربة على نظرية "المخططات الذهنية" التي ترى أن العقل الإنساني يخزّن الخبرات والمعارف في بنى معرفية منظمة تُسمّى مخططات، تُستدعى تلقائيا عند مواجهة نص أو موقف جديد لتساعد على فهمه وتأويله، وتستفيد المقاربة من هذه النظرية في تفسير آلية الاستدعاء؛ فالنص الأدبي لا يثير الذاكرة الجمعية مباشرة، بل ينشّط مخططات ذهنية كامنة في وعي القارئ، فتتولد منها الصور الذهنية والمعاني الموازية التي تشكّل جوهر الفعل الاستدعائي.
تُميز المقاربة الأدبية الاستدعائية بين الاستدعاء الجمعي، وهو ما ينشّطه النص من رموز وصور في الوعي الجمعي المشترك، والاستدعاء الفردي القائم على التجربة الذاتية، مركّزة على الأول بوصفه مجال التحليل النقدي المشروع. فالاستدعاء الجمعي يمنح القراءة طابعا موضوعيا وثقافيا، ويُبقي النص منفتحا على تأويلات إنسانية متجددة.
يتخذ فعل الاستدعاء (استدعاء النص الأدبي لصور ذهنية من الذاكرة الجمعية) شكلين: عفويا يحدث فور التلقي استجابة لمضمون النص، وتأمليا ينشأ بعد التدبر. الأول يُعدّ جوهر المقاربة لأنه يكشف عن التفاعل التلقائي بين النص والذاكرة الجمعية.
ومن خلال هذا الفعل، يتحول النص الأدبي إلى مرآة لذاكرة الإنسان الكبرى، ويغدو التلقي ذاته ممارسة إبداعية تنتج معنى جديدا يعيد وصل الحاضر بالماضي، والفردي بالجماعي، والرمزي بالإنساني.
وهكذا تؤسس "الاستدعائية" لرؤية نقدية تجعل من الذاكرة الثقافية عنصرا فاعلا في إنتاج المعنى، ومن القراءة فضاء للتجدد الرمزي والتاريخي، بحيث لا يُفهم النص إلا من خلال ما يوقظه في الوعي الجمعي من صور ومعان تتجاوز حدوده الأصلية نحو أفق إنساني أوسع.
ولتبيان آلية اشتغال المقاربة الاستدعائية بوضوح، سأعمل على تطبيقها على رواية "أجراس القبار" للروائي الأردني مجدي دعيبس. ولم يأتِ اختياري لهذه الرواية مصادفة، بل لأنها كانت الشرارة التي أوحت لي بهذه الرؤية النقدية؛ إذ تجسّد قصة الرسالة المسيحية التي تستدعي في بنيتها العميقة الرسالةَ المحمدية.
لقد صورت "أجراس القبار مدينة عمان في العهد الروماني حين كانت تدعى (فيلادلفيا)، كما سلطت الضوء على القمع الذي تعرض له المؤمنين المسيحيون على يد الدولة الرومانية الوثنية. كثيرة هي العبارات والجُمل والمشاهد التي تستدعي من ذاكرة القارئ الجمعية صورا وأحداثا شتى، ومن هذه الجُمل ما صرح به أحد الجنود الرومانيين: "...أصدر الإمبراطور دقلديانوس أمرًا بهدم الكنائس..." (ص 11)، فتنهض في الذاكرة الجمعية صور موازية من واقعنا المعاصر، صور مئات المساجد التي قصفها الاحتلال في غزة بعد السابع من أكتوبر لعام (2023)، بالإضافة إلى (3) كنائس دُمّرت أيضا تدميرًا كليا: كنيسة القديس (برفيريوس) للروم الأرثوذكس، والكنيسة الأسقفية الإنجيلية (المستشفى الأهلي العربي المعمداني)، وكنيسة العائلة المقدسة (دير اللاتين). في لحظة التلقي هذه، يستدعي النص من ذاكرة القارئ الجمعية صورة حديثة لفعل الهدم ذاته، وكأن التاريخ يعيد إنتاج مشهد الاضطهاد الديني بوجوه جديدة وأسماء مختلفة أحيانا ومتشابهة أحيانا أخرى. إن هذا الاستدعاء النصي لا يكتفي بإقامة مقارنة زمنية، بل يُولّد طبقة دلالية أعمق تكشف عن ثبات جوهر الإنسان رغم تبدّل العصور؛ فالتقدّم الفكري والعلمي والحضاري لم ينجح في كبح نوازع البطش التي تتغذّى على الكراهية. وبهذا يتّسع النص الروائي من واقعة تاريخية محدودة إلى شهادة إنسانية كبرى على تكرار الجريمة ذاتها: ازدراء المقدّس، وتجاهل حرمة الآخر، واستمرار البطش كجزء من سلوك جمعي متوارث.
في موضع آخر من النص يتحدث السارد عن الإمبراطور (دقلديانوس) في الإسكندرية والإمبراطور (مكسيميانوس). وأن الاضطهاد في عهدهما قد استعر "ووصل إلى حد الجنون، خاصة بعد تنصيب الإمبراطورين إلهين." (ص 23) فيستيقظ في الذاكرة الجمعية للمتلقي صدى التاريخ القديم، لتنطبع في ذهنه صورة فرعون موسى، الذي أعلن نفسه إلهاً متحديا السماء، كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَـٰأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرِى...﴾. في هذا التوازي الاستدعائي، يتحول النص إلى مرآة للوعي الجمعي، حيث تتلاقى صورة الإمبراطورين مع صورة فرعون، لتؤكد أنّ كِبْر الإنسان وبطشه واستعلائه لا يتوقف حتى على أتباعه وأبناء جلدته، مهما تغيّرت العصور والأسماء. الاستدعاء هنا لا يقتصر على مجرد استحضار شخصية تاريخية، بل يفتح أفقا دلاليا يربط بين الظلم القديم والحديث، ويبرز في النص طبقة ثانية من المعنى: استمرارية استخفاف بعض القادة بقومهم والتدليس عليهم في مختلف الأزمنة.
في مشهد آخر من الرواية، يصف السارد مشهدا للتسلية كان من ضمن ثقافة المجتمع الروماني فيقول: "في ساحة الكولسيوم في روما. أعجبتهم عروض المجالدين أو المصارعين. هي مجرد عروض للتسلية للجمهور...الحضور كانوا من الأطفال والنساء والرجال. أثارهم منظر الدم وأصبح القتل في نظرهم جزءا من الثقافة التي لا تعيب." (ص 29) وفي هذه اللحظة تنبثق في وعي القارئ صور أخرى، استدعاء تلقائي من الذاكرة الجمعية المعاصرة: المصارعة الحرة، الملاكمة، ومصارعة الثيران ، حيث يدخل (الماتادور) الحلبة ليصارع الثور الهائج بسيفه وردائه، ولا يخرج منها إلا قاتلا أو مقتولا! هذا الاستدعاء لا يكتفي بإجراء مقارنة بين الماضي والحاضر، بل يُفعّل طبقة دلالية جديدة للنص، تكشف ثبات نزعة التسلية الجماعية بإراقة الدماء والاستمتاع بمعاناة الآخرين عبر العصور، ليؤكد النص عبر فعل الاستدعاء أن الفرح بالموت والألم لم تتزحزح جذوره من التاريخ الإنساني.
ويطرح النص فيما يطرح أيضا تساؤلا محوريا فيقول: "ماذا لو أن ما يفعله الرومان بنا اليوم سيفعله المسيحيون ببعضهم البعض عند اختلاف رأيهم وتفرق كلمتهم في الغد؟" (ص33)، وفي هذه اللحظة ينبثق في ذاكرة القارئ الجمعية استدعاء تلقائي للصراعات الدينية التي شهدها التاريخ المسيحي، وأهمها حرب الثلاثين عاما (1618-1648)، والتي كانت نزاعا دينيا بين الكاثوليك والبروتستانت، وانتهت بمقتل (6) ملايين إنسان تقريبا، بهذا الاستدعاء، يتجاوز النص الفظاعات التي قام بها الرومان تجاه المؤمنين المسيحيين ليكشف عن دورة مأساوية من العنف الداخلي بين أبناء الدين الواحد. تتضافر الصور في وعي القارئ، فتبرز طبقة دلالية ثانية تُظهر أن الانقسام والتعصب قادران على تحويل الإخوة إلى أعداء يسفك بعضهم دم بعض، وأن غياب روح التسامح ستجعل قابيل يقتل هابيل من جديد.
في موقع آخر يقول أحد الزهاد الذين يقطنون أطراف الصحراء لـ (زينون)، الشخصية الرئيسة في الرواية: "ولد المسيح بكلمة الله لعذراء اسمها مريم... جاءها ملاك الرب وقال لها: ستحبلين وتلدين طفلًا تسمينه يسوع، خافت خوفا شديدا وقالت له: كيف أحبل ولست أعرف رجلا؟ فقال لها: قدرة العلي تظللك والمولود منك قدوس." (ص 22). تقوم هذه الجمل المقتبس معناها من الإنجيل على بالتحرك نحو مشهد مشابه، فتستدعي تلقائيا صورا ذهنية طبعتها في الذاكرة الجمعية آيات كريمة من سورة مريم تناولت الحدث ذاته، حيث يقول تعالى: ﴿وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًۭا شَرْقِيًّۭا ١٦ فَٱتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًۭا فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًۭا سَوِيًّۭا ١٧ قَالَتْ إِنِّىٓ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَـٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّۭا ١٨ قَالَ إِنَّمَآ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَـٰمًۭا زَكِيًّۭا ١٩ قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَـٰمٌۭ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌۭ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّۭا ٢٠ قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌۭ وَلِنَجْعَلَهُۥٓ ءَايَةًۭ لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةًۭ مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًۭا مَّقْضِيًّۭا﴾. في هذا الاستدعاء، لا يحدث التوازي بين نصين دينيين فحسب، بل يتفاعل النص الروائي مع المخزون الجمعي للقارئ صاحب الثقافة الإسلامية، فيستيقظ داخل وعيه الرابط العميق بين الروايتين المسيحية والإسلامية، اللتين تلتقيان في صورة العذراء مريم الطاهرة وفي المعجزة التي تخترق ناموس الطبيعة. هنا يصبح الاستدعاء فعلاً توحيدياً رمزياً، يردّ القارئ إلى الجذر الإيماني الواحد الذي يجمع بين الشريعتين السماويتين، ويكشف أنها دين واحد. إن أثر الاستدعاء في هذا الموضع يتجاوز حدود التذكّر إلى إعادة بناء المعنى الديني نفسه؛ فالنص لا يكتفي بسرد معجزة ميلاد المسيح، بل يُعيد تشكيلها بوصفها رمزا للتواصل بين رسالتين، ومرآةً للتقاطع الروحي بين الثقافتين الإسلامية والمسيحية. بذلك يُنتج الاستدعاء بعدا إنسانيا رحبا، يجمع ويعيد إلى المقدّس وجهه المشترك في الوعي الجمعي.
في مشهد آخر، تصف فيه الرواية زوجة حاكم فيلادلفيا وهي صغيرة، ذات الأربعة عشر عاما، وهي تفاجأ بخادمتها العجوز تصلي، فتسألها: "أأنت مسيحية؟"، فتجيب الخادمة بثبات: "نعم أنا كذلك؟" (ص 174)، وهنا تنهض من الذاكرة الجمعية صورة أخرى بعيدة الجذور، صورة ماشطة ابنة فرعون في التراث الإسلامي، تلك المرأة المؤمنة التي كانت تخدم في قصر فرعون رغم ادعائه الألوهية، وحين كُشف إيمانها بالله ثبتت ولم تنكر فقتلت مع وأولادها، ودخلت التاريخ مثالا لإيمان لا يزول بالرهبة ولا بسطوة السلطان. يحدث هذا الاستدعاء العفوي لأن الوزن الرمزي للمشهدين واحد، إذ تتكرر عناصره في الوعي الجمعي، امرأة بسيطة في فضاء السلطة الفائقة، وإيمان صامت يواجه سلطة مدججة بالبطش، ولحظة سؤال تكشف ما وراء الصمت، وثبات يرفع المهمش إلى مرتبة القداسة الأخلاقية. هنا لا يعمل النص على مقارنة تاريخين فحسب، بل على فتح طبقة دلالية تتجاوز زمن الرواية، فتتحول الخادمة من شخصية سردية ثانوية إلى صورة رمزية للثبات على العقيدة، تماما كما ارتقت ماشطة ابنة فرعون من كونها شخصية هامشية في البلاط الفرعوني إلى رمز خالد للصبر واليقين. إن المشهد لا يخلق معنى جديدا فقط، بل يعيد ترتيب العلاقة بين الضعف والقوة، فالقوة في هذا الاستدعاء ليست في يد الحاكم، بل في قلب الخادمة، والمكان الذي يفترض أن يكون مركزا للهيمنة، القصر، يتحول إلى مسرح لتحدي السلطة والتمسك بالتوحيد. وبذلك يصبح هذا الاستدعاء أداة لإعادة تأويل السلطة، فالسلطة المادية تظهر زائلة، بينما السلطة الروحية خالدة، ومن خلال هذا التفاعل بين النص والذاكرة الجمعية، تتحول الرواية من سرد لحادثة تاريخية إلى تجسيد لفلسفة إنسانية ثابتة، أن الإيمان كيفما كان شكله قادر على زحزحة أعتى العروش، لأن العروش تحميها العساكر، أما الذين آمنوا فيدافع عنهم رب العالمين.
حين تكشف الرواية عن موقف زوجة الحاكم الروماني الوثني وهي المسيحية المؤمنة التي تتوسّط لدى زوجها ليعفو عن (زينون) وتقول له محاولة توجيهه نحو قرار عادل، "ربما تكون القضية كيدية ووسيلة لتصفية الخصوم." (ص 175) فإن هذا المشهد لا يمر على القارئ مرورا عابرا بل يستدعي مباشرة صورة امرأة أخرى من الذاكرة الجمعية الدينية صورة (آسية) زوجة فرعون المرأة المؤمنة التي عاشت في كنف حاكم جائر يدعي الألوهية لكنها لم تتخل عن إيمانها ولم تمنع نفسها عن التدخل في لحظات الظلم. إن التشابه بين المشهدين ليس مجرد تواز حكائي بل هو استدعاء رمزي يفعّل ذاكرة القارئ على مستويات متعددة إذ نرى اجتماع الإيمان والكفر داخل البيت الواحد، فزوجة مؤمنة تحاول تحريك الرحمة في قلب رجل السلطة وهذا التقابل يكشف أن الإيمان ليس بالضرورة امتدادا للبيئة، وأن الضمير قد يولد في أكثر الأماكن ظلمة. كما نرى تحول بيت الزوجية إلى ساحة صراع بين العدل والاستبداد، فكلا المرأتين زوجة الحاكم الروماني، و(آسية) تقفان أمام سلطة لا محدودة لكنهما لا تصطدمان معها وجها لوجه بل تحاولان إعادة توجيهها من الداخل عبر خطاب الرفق والعدل، وتذكير الحاكم بحدود القوة الإنسانية. كذلك يمنح المشهد الهامش قوة رمزية تفوق سلطة المركز، فبينما يمسك الرجل بسدة الحكم والسوط والسجن، تمسك المرأة بالقيم وبهذا تتحول الزوجة في المشهدين من شخصية تابعة، وهامشية اجتماعيا إلى مركز للتصدي للعنف.
إضافة إلى الاستدعاء الديني الذي يربط بين زوجة الحاكم الروماني وزوجة فرعون فإن المشهد يستدعي كذلك على المستوى الرمزي صورة ثنائية الين واليانغ كما تشكلها الذاكرة الثقافية العالمية حيث ينقسم الفضاء الواحد إلى قوتين متضادتين تتعايشان تحت سقف واحد فبيت الحاكم يتحول إلى مجال صراع داخلي بين قوة الظلم والقوة المضادة له، فالحاكم الوثني يمثل قوة القهر القاسية الداكنة، وزوجته المؤمنة المسيحية تمثل قوة الرحمة الرطبة الوادعة المضيئة. وهكذا تتجلى الثنائية داخل المشهد: أسود وأبيض، بطش ورحمة، قوة السلطة وقوة الروح، لكن ما يجعل هذا المشهد فاعلا في ذاكرة القارئ ليس التضاد وحده، بل التوازن المتوتر فالمرأة لا تمثل نقيضا كاملا لسلطة زوجها، بل قوة ضغط أخلاقية تعمل من الداخل، كما لو أنها تحاول إعادة توزيع الطاقة الرمزية داخل البيت نفسه. وبهذا يتحول البيت إلى حقل صراع معنوي، لا ينتصر فيه السوط أو الضمير، بل تستمر الحركة بينهما في محاولة دائمة لإعادة صياغة المعنى والعدالة ومن ثم فإن الاستدعاء لا يكتفي بإنتاج صورة تاريخية أو دينية بل يوصل النص بالرمز الفلسفي ليظهر أن الإنسان يعيش دائما في ثنائية متوترة بين ما يستطيع فعله وما ينبغي عليه فعله.
في نهاية الرواية، تناوب جنديان رومانيان على تعذيب (زينون)، فـ"جلداه بسياط من جلود البقر بقسوة مفرطة... كان يصيح بين الحين والآخر: سأقدم الذبيحة لله الواحد رب السماوات." (ص 167) هنا، بعد هذا المشهد، وهذا التصريح، تستيقظ في ذاكرة المتلقي الجمعية صورة مقابلة من صدر الإسلام، حيث يتجلى في الذهن مشهد الصحابي بلال بن رباح رضي الله عنه، الذي كان يُخرَج إلى الصحراء ويُجلد ويُعذَّب على يد سيده أمية بن خلف ليترك الإسلام، مع ذلك كان يردد:" أحدٌ، أحد." المشهد هو المشهد والتصريحان يؤكدان الإيمان بوحدانية الله رب العالمين. هذا الاستدعاء يفتح أمام القارئ طبقة دلالية جديدة، تتجاوز الحدث التاريخي للرواية، لتكشف وحدة الخطاب المسيحي المسلم، فلاهما يقر توحيد الربوبية: الرب المدبر الواحد الذي لا شريك له. كما تؤكد هذه الصور الذهنية الثبات على الإيمان أمام البطش والطغيان عبر العصور. فكما انتصرت المسيحية على الوثنية الرومانية، انتصر الإسلام على بطش مشركي مكة، لتظهر قدرة الإنسان المؤمن على تجاوز العنف بالصبر والثبات. مع ذلك، فالأثر الدلالي الأعمق يتجلى في المفارقة الرمزية التي يخلقها النص عبر هذا الاستدعاء فلقد خرج بلال رضي الله عنه من رحم العذاب إلى الحرية والكرامة عندما اشتراه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأعتقه، ليصبح بعد ذلك مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما (زينون) فانتهى به الأمر شهيدا موحدا. ويعود ذلك إلى سببين رئيسيين: أولهما أن العقيدة المسيحية الأولى دعت إلى السلام، والصبر على الأذى، وعدم المقاومة، "أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم." (إنجيل متى 5:44). أما السبب الثاني فيرجع إلى استحالة انتصار قلّة من المسيحيين المؤمنين على الإمبراطورية الرومانية التي امتدت في قارات ثلاث؛ ولنفس هذا السبب لم يقاتل المسلمون في مكة مشركي قريش، فقلة العدد وضعف العدّة تجعلان من المواجهة أمرا مستحيلا.
في ضوء ما تقدّم، يمكن القول إن المقاربة النقدية الأدبية الاستدعائية تمثل إضافة نوعية إلى حقل النقد الأدبي العربي والعالمي، إذ تمنح النص الأدبي بعدا ديناميكيا جديدا، يجعله فاعلا في تحريك الذاكرة الجمعية واستثارة رموزها وصورها العميقة. فالاستدعائية لا ترى النص ككيان مغلق أو منتج للمعنى بذاته، بل تعتبره محفزا لإعادة إنتاج المعنى من خلال التفاعل بين اللغة والذاكرة الثقافية، بين الفردي والجمعي، بين الماضي والحاضر. إن ما تقدّمه الاستدعائية من جديد هو تحويل فعل القراءة إلى فعل استدعاء ثقافي، يشارك فيه القارئ والنص معا في بناء المعنى عبر المخزون الجمعي للصور والرموز. وبهذا تتجاوز المقاربة حدود المناهج النصية والبنيوية لتؤكد أن الأدب لا يعيش في عزلة عن الذاكرة الجمعية. كما تختلف عن المناهج السياقية في أنها تنقل مركز التحليل من سياق الكتابة إلى سياق القراءة، ومن المجتمع الخارجي إلى الذاكرة الجمعية للقارئ، لتجعل التفاعل بين النص والوعي الثقافي للقارئ مصدر المعنى الحقيقي.